محاولات تعطيل العقل العربي
خاص “المدارنت”..
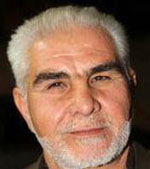
منذ زمن مضى، وتستمر المحاولات إلى تعطيل العقل العربي، الذي كان ولا يزال، يحيا داخل طوفان من صراع مذهبي، شرقي وغربي وصهيوني عنصري. والهدف من كل ذلك، تقويض أسس وركائز هذا العقل المتميز عبر التاريخ، وهدم مقوماته الحيٌة، ثم استنزاف قواه، ومحو معالمه العلمية، حيث تقف جوقة الغزاة ومقلديهم من أبناء الأمة العربية، الذين يتناقضون بكل وضوح مع هوية وأصالة الإنسان العربي، حيث تكاتفت وتكالبت الأفكار العدائية، من أجل عرقلة، بل تعطيل تيار الفكر العربي الموحد، ومن أجل تضييع معالم الثقافة العربية – القومية والدينية، وأنها تعمل وباستمرار إلى نسج المخططات وحياكة طرق الضياع والمحالات، لتفكيك وتفتيت ذلك العقل، متخفية وراء ما يسمى “التقدم والتقدمية”.
والاجدر بنا أن ننوه إلى أن هذا المصطلح، انما هو تعبير عربي أصيل وقديم، حمل في طياته معنى التقدم والإقدام، اي تطور الفرد والمجتمع على السواء، حيث جاء المصطلح في تعبيره العربي على غاية من الأهمية والصدق في تنشئة الفرد وبناء المجتمع، على الحرية والحق والسواسية والعدل والسلام. ونستدل إلى معناه العربي الاصدق والاقوم في مناسبات من مراحل نشر الدعوة الاسلامية، الدالة إلى التقدم والإسراع إلى المقدمة .
١- لقد ظهرت كلمة “التقدمية” في شعر أمية ابن أبي الصلت، وهو يُرثي قتلى غزوة بدر الكبرى، فيقول: القائلين الفاعلين الآمرين بكل صالح الضاربين التقدمية بالمهند الصفائح. أنه قتال الاستبسال “تقدمية”، كما أنه يقدم صورة حسية للتقدم، متجاوزا كل العوائق للوصول إلى الصفوف الاولى، وهكذا، حتى يبقى في حياتهم طريق التقدم بالحرية، في تطور الإنسان، مفتوحا أمامهم وممتدا ..
٢- لقد استخدم الرسول الكريم، ص، كلمة “التقدم”، وهو يقود تقدمية قريش، ويصحح اتجاهها بمعناها التاريخي، والدالة على التقدم إلى الامام، اي دفعهم من الغفلة إلى الصحوة، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن حياة الترف الشخصية الفردية، إلى الجماعة والمساواة في الحقوق والواجبات. وهذا ما كان يردده، ص، وهو يشارك أصحابه أعمال حفر الخندق، كي يشدّ به عزائمهم. وهذه هي الأبيات:
تأخرت استبق الحياة فلم أجد لنفسي حياة غير أن وتقدما
فليس على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدٌما
نغلٌق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعقٌ وأظلما
أنه المعنى العربي الأصيل والقويم لمعنى التقدمية، الذي أرسى به الإسلام في اشراقه، وفي مراحل نشر دعوته، فغاية “التقدمية” في الإسلام: أن تعي الحق، وتقاتل عن الحق، وتثبت الحق، كي يتم التقدم ويتجاوز العوائق كلها، لتحقيق الحرية والعدل والمساواة .
إن أقرب تواريخ التخطيط لغزو وتعطيل العقل العربي، وابقاءه في مهبّ الريح، وداخل مجرى العواصف، انما تظهر عقب الحروب الصليبية المتكررة، وهزيمة الحقد الاوروبي، الذي لم يحقق اهدافه، على الرغم من تجدد حملاته العسكرية الوحشية، على مدى قرنين من الزمن. إنه العدو الأزلي الأبدي، الذي توصل بتحقيقاته ودراساته لوقائع تلك الحروب، إلى أن الأفضل هو استبدال تلك الحروب العسكرية، بما يضمن تعطيل العقول، وما يغرر النفوس، وما يضلل القلوب، فانصبت جهودهم الناشطة، وابتكاراتهم نحو هذه الأنواع من الحروب، التي أنتجت صراع الكلمات والافكار، اضف الى رفع الشعارات الفارغة المضللة، والتي يفوق فتكها وتدميرها ضربات الجيوش الجرارة.
هذا الوجه من الحروب، لهو أحوج إلى صناعة متنقلة تحمل الوان اكاذيبهم واوهامهم، تبث مخدراتهم العقلية، وسمومهم الفكرية، فكانت صناعة الاستشراق، إضافة لاختراع وسائل وفنون ومعاهد، كي تشكل فرق خداعية هجومية، تشرف عليها هيئات متخصصة، دينية أو علمية أو سياسية، توجهها وتنشئها على عدوانية العرب، وكراهية الاسلام، آخذة بضرورة تعلمهم اللغة العربية، التي من خلالها، يستطيعون القضاء على اهلها، ولكن هذه الحرب، من غير ضجة ولا اعلام .
الغاية، كل الغاية، زرع واستنبات الأفكار السرابية المميتة، فيدسونها في طيات كتبهم: عن الرسول، ص، عن الإسلام، عن اللغة العربية، عن التاريخ العربي، إضافة لتنمية مشاعر الحقد بين الفرق والمذاهب الالحادية، ثم تحرك احاسيس منابعها، من فارسية ويونانية وهندية. وبهذا جعلوا لكل نظرة فلسفية، ولكل أيديولوجية، مدرسة لها اتباعها ومناصروها، كما أنهم فرضوا تدريسها في جامعاتنا الوطنية، من باب حرية الفكر والتعبير، من باب حرية الاطلاع والمعرفة، في الوقت نفسه، منعوا دراسة اللغة العربية إلى جانب العلوم الدينية في تلك الجامعات والكليات، بحجة محاربة العصبية والتعصب، على الرغم من أنهم يدرسونها في جامعاتهم الاجنبية الاوروبية، وبهذا قوٌضوا ركائز العقل العربي، وفككوا عناصر مقومات الفكر العربي، من تحفيظ القرآن العظيم، وما حمل من حفظ اللغة العربية، وما تضمنه من قيم أخلاقية وسلوكية.
لقد استمروا تنكيلا، وثابروا عملا على شطر الذات العربية، وهوية المجتمع العربي إلى شطرين متناقضين متنافرين، “مدني وديني”، على الرغم من أنهما لا يعيشان ولا ينموان الا بوحدة لحمتهما. وهكذا تسرب الخطر الأعظم، وسرى سريان الدم في العروق، متسترا برداء أملس، ناعم خفي، ولا يزال، متغطرسا بكيده السافر، وحقده الدفين، متأصلا ما بين صليبية الغرب وضلالة المجوس، وما الحال التي نعانيها، وتربعت فوق صدورنا، انما وصلتنا بعد أن تمٌ للصهيونية العنصرية العالمية، ممارستها لمثل هذا الغزو الفكري والعقلي على أوروبا خصوصا، والغرب عموما، حيث كانت حقل تجارب لمثل هذا التدمير الحضاري، إذ قاد تلك البلاد إلى التخلي عن طابعها اليوناني واللاتيني والجرماني القديم، فحوّلها إلى كيان فكري مصطنع، كيان منفصم عن إرادته الطبيعية، كيان عاجز عن التكيف الذاتي مع جذوره التاريخية، فتنكر لماضيه المسيحي، ونما فكره وعقله على هياكل من النظريات الوهمية والقائمة على أشكال من تصنيع الأفكار، ثم توزيعها في كل الاتجاهات، وكل المجالات الحياتية، حتى غدت الأفكار طينة لينة طيٌعة قابلة للتشكل، لصالح القوى الصهيونية العالمية، التي خلقت هذه الصناعة الفكرية من أجل الترويج لنظريات وايديولوجيات ظنية، غايتها هدم عقيدة التوحيد، ونشر ديانات بشرية وضعية، اي استبدلت الإله الخالق الواحد، بألهة بشرية متعددة، هذه الآلهة البشرية حلت محل تقديس وعبادة لشعوبها، ومن جهة ثانية، خضعت لقبضة القوى الخفية، قبضة الصهيونية العالمية .
وهكذا، أصبح من الطبيعي أن تكون الأمة العربية الاسلامية، هدفا رئيسيا واساسيا لمثل هذه الحروب، وهذا التعطيل الفكري والعقلي، اي حرب النظريات والاديولوجيات التي حاصرتها من كل حدب وصوب، وهنا وجب التنويه إلى أن امتنا العربية الإسلامية تعتبر الأقوى، من حيث العقيدة عالميا، وستبقى، إن عادت وتوحدت مرة اخرى على لغتها، على دينها، على مقوماتها، على مصيرها وعلى تاريخها، كما ننوه إلى أن عدوها من صهيونية ومن لفٌ لفٌها، من أقارب وجيران، يعلمون كل العلم أن العرب هم أعظم الأمم استعدادا لقيادة العالم، لأن مبعث قوتها ربّ العالمين، وما رسولها ، ص، بُعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق، فما عليهم من أعداء الامة إلا ليقوضوا كل القيم والفضيلة والاخلاق. فهم يخشون وحدة الامة، كما يهابون يقظتها وصحوتها، لذلك كانت الخطوة الأولى في التقسيم والتفتيت، هي الاستيلاء على أرض فلسطين العربية، جاعلينها مركزا لتحقيق أهدافهم على أنقاض أمة العرب والاسلام.
والآن.. الأمة العربية ـ الإسلامية تئن تحت مخاطر هذا الظلام، وتتألم في مواجهة هذا الخداع وهذا الصراع، فنرى الإنسان العربي يفتش عن النور الهادئ، باحثا عن عقله وعن هويٌته، عن ذاته وعن اصالته، يطلب كلمات مشرقة تحكي قصص تاريخه، يريد موجة خلاص بين أمواج متلاطمة متصارعة، فلا يجد سوى تلك الضربات الصاروخية، القادمة إليه من اهل الشرق وأهل الغرب، التي تدفعه الى الخضوع لذلك المخطط الصهيوني الخفي. فالعرب يحيون صراعا مستمرا بين الواقع وبين الذات، يحيون مسلوبي الارادة والحرية، منهوكي القوى تحت ما يحملونه من أيام عزّ عاشوها اماداً طويلة، يتساءلون كيف الاسترجاع وكيف الرجوع؟
الإجابة واضحة، كأنها النور أمام اعينهم، تلك الأعين التي أمامها، تذوب هويتهم، وتضيع اصالتهم، وتندثر مقوماتهم. نعم، معهم نتساءل؟ كيف الرجوع وهم ساكنون؟ وهم لا يتحركون، وهم لا يفكرون، وهم لا يتدبرون، وهم لا يستذكرون فيذكرون، لقد تحوّلت أجسادهم حطاما وأشلاء داخل معركة إبادة مكتومة الأصوات، ساكنة الانفاس، نعم، إن الرجوع والاسترجاع يشعٌ من خلال ذلك النور الساطع، الكاشف، الثابت، الأزلي الأبدي، النور المتجدد، بمنهجه وغاياته واهدافه، ولكل زمان ومكان، أنه نور الله الحق، أنه نور القرآن العظيم.





