خصائص ومزايا الإنسانية في التصوّر الإسلامي.. ميزة الفطرية. / الجزء (6)/ أولًا
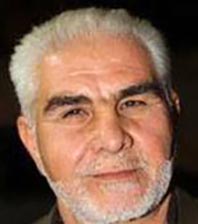
خاص “المدارنت”
الأخذ بالاسلام، كدين، يقتضي: الإلمام باصوله ومعرفة مبادئه والإحاطة بتشريعاته. أي أن يكون العالم، شاملا لمضمونه وكليته، إضافة للاطلاع على ما قدمه للبشرية من عقيدة تتجه إلى قلب الإنسان وفكره ونفسه وبدنه، ثم البحث عنه كمنهج أخلاقي، كامل متكامل، يضمن ثبات القيم الرفيعة لبني البشر، كما ويحفظ لكل مجتمع انساني تماسكه الاجتماعي إضافة إلى ضمان مصالحه.
وعلى هذا الأساس، يعتبر الإسلام، الشامل الكامل، ضمانة تحقق مثل العدالة والتنمية للمجتمعات البشرية، ويعتبر ايضا اعظم المناهج الدينية والدنيوية (الوضعية)، قواعدا وتشريعا، على السواء، بحيث ينظر إلى الإنسان ويتعامل معه، باعتباره كيانا واحدا متحدا، له عقله وقلبه ونفسه، وله ايضا متطلبات وحاجات حياتية، بدنية منها وغريزية، يجب اشباعها.
لذلك، الإسلام يخاطب ذلك الانسان الفرد، ثم يجيبه عن تساؤلاته الفكرية وتطلعاته النفسية، إضافة إلى تحقق ما يحمله من فطرة تتعلق بادراكه وكيانه، إضافة لما يتفرع عن ذلك من علاقته بربه، بنفسه، بمن حوله وبما حوله. لذلك نجده (كدين)، أمام مخلوق عظيم، مميز، يحتاج إلى ما يحتاج، ليكون فاعلا، منتجا، مستقيما، فوضع (كتشريع) بين يديه ونصب عينيه، منهجا يشبهه وعلى مستواه الادراكي والعقلي العظيم. واجبا عليه السير في قوانينه وتطبيقاته، في السلوك والتصرفات كي يتمكن، حتما، من استشراف مستقبله، فيعمل على إسعاد نفسه واسعاد غيره، جراء ما اخذ وطُبّق، سالكًا سبل ما أنعم الله عليه من تمايز الحقائق باليقين المبين، مع النماء المستدام.
فالإسلام، باصوله ومبادئه وتشريعاته، إنما يمثل أعمدة متينة قوية، تضمن بناء وتكوين ذلك الانسان المميز والمتفرد بخصائص تحفظ دوام عمارة الأرض، ببقائه وتقدمه عبر مسار طويل، حياة ومصيرا، لاجيال متعاقبة.
هذا الاهتمام الشمولي العظيم اهتمام الإسلام بالإنسان، دليل ترسيخ الإنسانية في كليته، المادية والمعنوية، تطبيقا لما يدركه من معان ومضمون للنصوص القرآنية، فيقراها ويستمع إليها ويعمل بها إضافة إلى ذلك، يبين ذلك الاهتمام، وحدة الجنس البشري بانسانيته، أيّ أنه يفرض العمل بالرابطة الإنسانية التي تقوم على أساس ارتباط الناس فيما بينهم، ثم ارتباطهم بالخلق العظيم.
من جهة ثانية، الخطاب الإلهي موجه لكافة الناس وللعالمين أجمعين، ولم يكن موجها الى العرب المسلمين وحدهم، أو لأيّ قوم معيّنين ومحددين. وبهذا الخطاب الالهي، يبرز التلاؤم والانسجام مع فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها. يعني أن الحياة الإنسانية إنما تخضع لنظام دقيق محكم، يُلزِم التوازن في جوانبها كلها. هذا النظام وأحكام توازنه إنما يتميز بخصائص وميزات تأخذ الإنسان إلى إنسانيته الحقة، علما وعملا،
وتتلخص تلك الميزات بـ:
أولا: ميزة الفطرية
الفطرة عامل ذاتي، وتعني الخَلقُ والبدء. لقوله تعالى: “الحمد لله فاطر السموات والأرض”، فاطر/ 1. وتعني ايضا، ما فطر الله خلْقَه عليه من معرفتهم به. لقوله تعالى: “فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله” الروم/ 30. بمعنى اتباع علم الله والإيمان به
وهذا قول رسولنا الكريم (ص):” كل مولود يولد على الفطرة..”، والمعنى أن الإنسان يولد على الجبلة أو الطبع، الذي يقبل الدين وكل تعاليمه. انظر لسان العرب/ مادة فطر.
كل ما تقدم يأخذنا بدليل أن الناس مفطورون على معرفة الله تعالى، عن طريق البحث في أنفسهم، وهو أمر لا يستطيعون له دفعا، إذ لولا هذا الوجود الفطري النفسي الداخلي (من قابلية وقبول) لدى الانسان، لما استطاع التعلٌم والتعليم والتذكر، ولما ذهب إلى التأثر والتأثير، في ذاته وفي كل ما يحيط به. وعلى سبيل المثال: قوة المحبة لا تأتي من الخارج، إنما هي شيء موجود داخل الذات وداخل النفس ايضا، ومن ينكر ذلك، إنما ينكرها إنكار العرف. لقوله تعالى:” وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا”. النمل/ 14.
فالدين الإسلامي هو الرادع العاصم من كل الأهواء والنزوات المتفرقة والتي لا تستند إلى حق، ولا تستمد من علم، إنما تشبع الشهوات والنزوات، بغير ضابط ولا دليل. لقد انبثقت الإنسانية من العقيدة الإسلامية، وقامت عليها، والتي هي من خلق الله تعالى، ابتداء وانتهاء. فالبدء يتمثل بخلق فرد انساني، والغاية العبادة الالهية، وفي الانتهاء يتمثل في سلوك ذلك الفرد الإنساني، وفي تصرفاته، بحيث يتعلق ذلك بكل ما يعكسه على ذاته من أجل تحقيق غاية البدء.
وكأنها تذهب بنا تلك الفطرة إلى لزوم إقامة الخير وفعله، والتي تهيأت لها القلوب المستقيمة والمقيدة بتشريع الدين، من أوامر ونواهي، ذلك التشريع الذي يعتبر السلطان القوي الذي به، تسطيع انوار النصوص القرآنية. وهكذا فالعلاقة جدلية بين فطرة النفس الإنسانية وبين طبيعة ما جاء به التشريع الإسلامي الحنيف. إضافة إلى وجود تناسق عملي في الطبع والاتجاه، أي بين الوسيلة والغاية. فالذي خلق القلب البشري، هو نفسه المصدر الأوحد الذي أنزل اليه ذلك الدين وتشريعه، لغاية وأهداف تحكمه وتقوٍمه من الانحراف.
فالفطرة هي، هي لدى البشرية جمعاء، وهي ثابتة لا تغيير في خلق الله، والدين ايضا، واحد وثابت، فالمصدر واحد والتشريع واحد، ونلفت النظر إلى أن الانحراف العملي والسلوكي، لا يردعه إلا الإيمان الحق بهذا الدين، المتناسق والمنسجم مع طبع الإنسان وفطرته. وهذا يعني أن الإسلام، قد ترك بصمات الفضيلة والقيم، داخل المجتمعات الانسانية، وأثبت للانسانية جمعاء أن إمكانية تذوق طعم السعادة والشعور بالرضى الوجودي، إنما هو حاصل مؤكد، شرط اتباع المنهج الإلهي الذي يهدف إلى إقامة التوازن والتكامل والتكافؤ الإنساني في خضم الحياة الاجتماعي، على كافة الصعد.
الجدير ذكره، يمكن الفطرة أن تتغير وتتجه نحو الأسوأ، بعيدة عن كل استقامة، وهذا الأمر إنما يقع نتيجة تأثير خارجي على الذات الإنسانية، سببه تصرف وسلوك الوالدين، ثم البيئة المحيطة بما تحمله وتحويه من مؤثرات، استنادا الحديث الرسول (ص): “كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه..”، ولكن الأساس، مع ضرورة بيان: أن اتبع الإنسان فطرته السليمة، فإنه سيتوجه، حتما، وبكليته باحثا عن المثل العليا، التي توصله إلى الملا الأعلى.
يعني ليس بالإمكان الحديث عن مجتمع أو مؤسسة أو منظومة أو ادارة، دون عقيدة، دون دين، فالدين ضرورة فردية اجتماعية. مع ضرورة التنويه إلى أن الانسان دائم النزوع والبحث لإدراك ما هو وراء ذاته، من موجودات لها علاقات مع ما يعقله ويحسه ويشعره، مما يؤثر ويتأثر به، وهذه العلاقات إنما هي وليدة تلك الفطرة التي تذهب بالإنسان إلى وجوب الأخذ بعقيدة تسهم وتساعد وتكشف له عن مكنونات تساؤلاته.
وعليه فإن أسس وأصول الإنسانية في الاسلام، إنما هي منبثقة عن منهج الهي رباني، يعني أنها ليست من إنتاج بشري أو بيئي كوني، إنما هي هداية إلهية لانسان موجود، يملك من قدرات وطاقات تميزه عن سائر مخلوقات الله تعالى، ويملك ايضا، من القوى البعيدة عن كل نقص أو ضعف أو انحلال، وهي إذ توافق وتنسجم مع ما فُطِر عليه، وتجدر الإشارة ايضا، إلى أن هجران المنهج الإلهي الرباني، إنما يؤدي حتما، إلى فقدان القيم والفضائل، ثم إلى انحلال الضمير الإنساني وموته.
وبهذا الموات، يحل طغيانا وظلما على النفس الإنسانية، فتنتهك القيم الأخلاقية بأيدي الناس أنفسهم، تصرفا وسلوكا ومنهجا، فيختل التوازن والتكامل الانساني، فتذهب الإنسانية ويحل السيّء والمسيء، والفاسد والمفسد، ويسدل الظلم استاره.. الخ. لقوله تعالى: “.. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون”، الروم/30.
العظيم
يأخذك الواجب إلى تحقق العلاقة بين الإنسان وخالقه العظيم، محاولا أن تكون على نوع من الاتزان والإدراك، وعلى أسس إيمانية متينة، تقوم على اصل أن الله تعالى هو المتوكل بأمور عباده، بحيث يتوجه الانسان ،من خلال هذا التوكل، القرار ذاته كي يحقق حياة استقرار وامن وطمانينة. لقوله تعالى: “الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب.. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب”. الرعد/28-29.
من هنا وجب وجب ضرورة ممارسة العلاقات الإنسانية بالاعتماد على الإيمان بالله تعالى، أي ضرورة الالتزام، قولا وعملا، بما شرّع الله تعالى وأتى به من نصوص قرآنية، مع الإشارة إلى أن كلية ما أتى به الله تعالى ،كدين، إنما يمثل دين الواقع العملي والحياة المعاشة،
دين عمل وانتاج، بحيث انه يربط بحركة علاقته بين المعتقد والعمل، بين القول والفعل، بين النظرية والتطبيق، بحيث تنطلق تلك الجدلية كي تصوغ مبادىء الانسانية،ثم صبغها بصبغة الواقعية الموضوعية. لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون”/ الصف/2-3.
نستنتج ذلك، أن الإنسانية وعلاقاتها، في التشريع الإسلامي، تتميز بميزة التوازن، أي توازن بين مطالب وحاجات الانسان، المادية والروحية. يعني أن الإسلام يلحّ ويؤكد ضرورة الأخذ وتطبيق التوازن بين حاجات الدنيا ومطالب الاخرة، مع لزوم إعطاء كل جانب حقه من الرعاية والاهتمام. لقوله تعالى:” وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا”. القصص/77.
يذكرون، الخير وفعله، والخير هو ما فيه منفعة خاصة وعامة، بحيث أن الإنسان لا يرى في اصل فطرته، إلا الخير، ثم لا يميل إلا اليه، أما الشر الذي يناقض الخير، إنما هو عارض طارئ. يعني أن الخير ذاتي والشر خارجي. وبهذا يمكن القول أن الإنسان مهما بلغ من شرور، يستحيل عليه أن يصبح شرا محضا. لذلك فإن الإنسان إنما ينشأ داخل منازعات ما يحيطه من عوالم واكوان، فتراه يتقلب متغيرا، بين حالات الراحة والاستقرار، حينا، وبين الجهد والغلبة، حينا اخر، أضف إلى أنه يتنافس ويتسابق مع أبناء جنسه على كسب المنافع. أما من ناحية اضطراره للظلم والافساد، فإنه يأتيه تعلما، بحيث يلازم ذلك الظلم مناداة ضميره الحيّ (قبل الموت) فيقول له: لا ،لا تفعل.
يعلن البيان، أن ما يصيب الإنسان من مكاسب ومنافع، إنما تصدر عن عناية الهية، أما ما يصيبه من شرور، إنما تصدر عن نفسه، أي أنها انعكاس لما ينتجه من أعمال. لقوله تعالى: “ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك”. النساء/79. فظاهر الغاية تبين أن الإنسان لا يأتي أعماله الاختيارية إلا إذا علم بنفعها له، أما ما ينتجه من سوء اعمال، فإننا تصدر عنه عن جهل وعدم معرفة بما ستعكسه تلك الأعمال. بهذه الحالة يستلزم اخذ العمل بالعقاءد اليقينية، أي ضرورة العمل بما يوافق الإيمان الصحيح مع منطق العقل الذي هو سلطان أعمال الإنسان. أي تطبيق مقولة: الحلال بيٍن والحرام بيٍن . خلاصة الكلام تعني أن كل علم لا أثر طيب له داخل العمل، يكون ناقصا لا يقين فيه. فالايمان الذي نطلب هو ذلك الإعتقاد اليقيني في العقل المهيمن على القلب. يعني ضرورة التوازن بين العقل كفكر وبين القلب كوجدان.
ان فطرية علاقة الإنسان بخالقه، دليل واقعيتها وثبات رسوخها العملي، وهي من الأهمية البالغة في التأثير على الأخلاق والسلوك والتصرفات الإنسانية في إطارها العلائقي الاجتماعي البشري. فالدين الإسلامي وما يحمله من دستور، وصور لتشريع، إنما هو كل ما يقبله العقل ويهتدي به الوجدان، كما أنه متطور لكل زمان ومكان، فينظم أحوال المجتمع، ويساوي بين الأفراد، ويطمئن النفس البشرية. فالايمان بالله الواحد الأحد فطرة إنسانية تنزع إلى التسامي في المعرفة المتطورة والمتدرجة للوصول إلى معرفة الله تعالى، صاحب القوة المطلقة التي يتمحور في فلكها ذلك المخلوق المتميز بفرديته،فيتعرف عليها جراء ما اسرت به النفخة الإلهية، وما وهبته له من نعمة العقل ،كأداة ميزته عن سائر المخلوقات.
تحصل النفس الإنسانية على العلوم والمعلومات، بقدر ما تكتسبه منها، عن طريق قوة ذاتيه تقتضي كسب معرفة هذه العلوم . مع الاشارة، إلى أن أعمال الناس متشابهة، ولكنهم كأفراد يتفاضلون، بالإرادة والقوى والأهداف.
إن السبيل الذي يسلكه الإنسان الفرد، والغاية التي يقصدها، إنما هي تلك التي ينتجها من عمله هو، وليس للقوة الإلهية من علاقة أو تدخل فيما اختاره هو لنفسه. من هنا وجب عليه كانسان، يخطىء ويصيب، أن يدرب إرادته ويعودها فعل الخير ثم يزكي نفسه على ذلك. لأن الأمر الذاتي إنما يستجيب لحالات تتكرر، فيتاثر بها ويؤثر ايضا. وهكذا يعتاد الإنسان فعل الخيرات وايضا، يعتاد سداد العقل وصواب تفكيره. بهذا يكتمل الإيمان بالله، أي بالعمل الخيٍر، والتمرّس يكرس الاخلاق، انطلاقا من أن النفوس البشرية ليست أوهام وليست خيال، إنما هي مشاعر واحاسيس، وإرادة حركية انفعالية.
لقد جاء الإسلام كدين، موافقا لطبيعة الانسان، ومراعيا عناصر تكوينه، الروحية والمادية والوجدانية، وهذا من لوازم فطرته، أما من ناحية إنه كتشريع، فانه يدفع بعناصر تكوين الإنسان للقيام بوظائفها
في سبيل عمارة الأرض واستمرار البشرية في تناسلها. يعني ضرورة تحقق إنسانية الإنسان، حيث تندمج رغبات الجسد مع اشواق الروح، من أجل تحقق غايات الحياة الوجودية ،التي أرادها الله تعالى
له كانسان مجبول على الفكر والشعور.
ثالثا: ميزة العالمية.
ما يميز الدين الإسلامي، في أصوله الانسانية، إنه وضع الهي، وما العقيدة إلا حاجة روحية وضرورة حتمية ، لصلاح وإصلاح حال البشر. فلا يختص بها فريق دون الاخر، يعني أن الأمر يحتم وجود دين أو تشريع عالمي يحمل في طياته نظام أو قانون يحمي ويحفظ معاني الإنسانية وابعادها العلاءقية . يعني أن يكون بين أيدينا، منهج تشريعي يحيط بعالم الإنسان ومكنوناته، من حيث أنه انسان. بغض النظر عن تلك العوامل والفوارق العارضة التي تدخل في ماهية الانسان. لقوله تعالى: “وما هو إلا ذكر للعالمين”القلم/52.
“وما ارسلناك إلا كافة للناس بشبرا ونذيرا “سبا/28. “وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين” الانبياء/107.
هذه الآيات القرآنية إنما تؤكد عالمية الإنسانية في الاسلام، من حيث أن الرسالة الإسلامية قد توجهت إلى الناس كافة، من أجناس وألوان. وعليه نخرج إلى حُكْمِ مقرر من رب حكيم، استنتاج طبيعة منسجمة متناسقة لوحدة المجتمع، من حيث عقيدته وانسانيته، فغاية الإسلام، ومن خلال دعوته في تحقق انسانيته العالمية، أن يؤمن جميع الناس به كدين سماوي مصدره خالق واحد ووحيد. وعلى هذا الأمر فقد حقق الرسول (ص) _ بعد إقامة دولة المدينة_ ونظم علاقاته مع جميع الناس على اختلاف اجناسهم واصولهم دون الإشارة لاي نزعة تسلط أو استعلاء. مع لفت النظر إلى أن الإسلام، عقيدة وتشريعا وادبا واخلاقا، هو خاتم الرسالات ونهاية الوحي الإلهي، فكان لزام الإنسانية جمعاء، الأخذ به وتحقيق تشريعه، كامة إنسانية عالمية واحدة. لقوله تعالى: “إن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون”/ الانبياء/92.
ولكي يكون الدين الإسلامي عالميا وصالحا لكل زمان ومكان، فإنه بلا شك قد تميز بخصائص ثلاث، هي:
# وفاء الإسلام لحاجة الإنسانية جميعا، فصان وحدتها ورعى انسانيتها.
# احتوى التشريع الإسلامي قيام الإنسانية كلها في عالم واحد، لا تنزع معها، عصبية دم ولا اختلاف لون ولا فرقة جنس.
# اتساق الإسلام مع حقائق الكون وخصائص الوجود، بحيث لا يتعارض مع ما أثبتته الحقائق العلمية ولا يختلف مع منطق العقل.
رابعا: ميزة الاستمرارية
تقتضي ميزة عالمية الإسلام التعرف على ميزة الاستمرارية، كضرورة حتمية، لأنها تعتبر مصدر من مصادر القوة التي دفعت الناس إلى التعرف على الدين وفهمه وادراكه وبيان مقاصده الانسانية، ثم قناعة الدخول في مساره الإنساني. فالاستمرارية تعني وتفيد، خلوده، عقيدة وتشريعا، مع دوام بقائه وامتداد رسالته، ما دامت البشرية تواصل حياتها على سطح هذا الكوكب، ومستمرة في تناسلها، تحقيقا إلى مشيئة الله تعالى.
فالإسلام دين يلازم البشرية في مسيرتها الإنسانية، كما أنه يحتوي ويستوعب مظاهر التجدد والنمو في كل ما يتعلق بتلك الانسانية، على كافة المستويات. لقوله تعالى: “أن الدين عند الله الإسلام “، آل عمران/19.
لا شك أن المنظومة البشرية، وما يحيط بها من إدارات ومؤسسات، إنما تتحدد غايتها وترتكز ايضا، على واجب القيام بالخلافة الإنسانية التي كرم الله تعالى بها الإنسان. لذلك وجب عليه لزوم التوجه إلى عبادة الله الواحد الأحد، ومن جهة ثانية، ويجب الاتجاه بعمله وطاقاته من أجل تحقيق الخير العام للناس جميعا. هذا الأمر اكسب الإسلام الطابع الشمولي العام وصبغه بصبغة الاستمرارية ، والمستمرة ابد الدهر. فتعاليمه الإنسانية ثابتة ولن تغيب عن الفكر والمنطق لأنها مجموعة حقائق جوهرية في أصول العقيدة والتشريع والادب والاخلاق، كما أنها محفوظة بين دفتي كتاب كريم. لقوله تعالى:” انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون “الحجر/9. كما أنها واقعية موضوعية، كونها تعايش الإنسان في جميع جوانب حياته. لقوله تعالى: “ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ” الاحزاب/40.
لقد راعت تعاليم الإسلام، سبل الارتقاء العقلي والمنطقي، لإبعاد مفهوم الانسانية، فايقظت العقل من ثباته، ودفعت بصاحبه
كمخلوق، نحو التطور والتدبر والنمو الحضاري،ثم وجهته نحو الآيات، في الآفاق وفي انفسهم، مما فرض عليه محاكاة الأدلة والبراهين. فبرز الإسلام، وفي كل مجالات الحياة الإنسانية، بروعة التوجيه والإصلاح السليم، بحيث لم يترك مشكلة ،كبيرة أو صغيرة، إلا ازالها ولا عقدة إلا حلها، ولا خطأ إلا واصلحه. فالإسلام اصّل الأصول والاسس ، وأقر القواعد والقوانين، ووحد الإنسان رشدا في بلوغه، فنزع في كليته نحو حرية الفكر واستقلال العقل. إذ بذلك فقد اُصلحت السجايا واستقام الطبع واستنهضت العزاءم، سعيا خلف خطى الاستمرارية الابدية.
خامسا: ميزة الشمولية
لقد اتسم الإسلام، بالاحاطة والاستيعاب والشمول، كونه تشريع كامل متكامل لكافة شؤون الحياة الإنسانية، سلوكا وعملا وتصرفات. كونه تعالى خالق السموات والارض ،ضمن وحدة متناسقة، تؤدي وظائفها طبقا للقانون الالهي وتصميمه الدقيق المتوازن. مع إلا النظر إلى أن الانسان ما هو إلا عالم خاص متكامل داخل هذه الوحدة الكونية. إلى جانب إنه يملك من قدرة الانتظام في محورها أو الخروج عليها. لذلك فهو مخلوق يحتاج إلى التوجيه والرعاية من أجل الحفاظ على توازنه النفسي والعقلي والجسدي ،حتى يستطيع الحفاظ على مواصفاته الإنسانية. لقوله تعالى:” انظر سورة العصر “. وهذا أمر واقعي موضوعي، و ثابت حقيقي، مما يجعله متطابق مع طبيعة وفطرة هذا المخلوق.
لقد اهتم الإسلام بكلية تكوين الإنسان الفرد، عقلا وقلبا وجسدا، وهذا الاهتمام، إنما يفرض العمل على نمو تلك الكلية واشباعها، مع شرط تحقق التوازن فيما بينها. وكل ذلك يتحقق بالتربية والتعليم والميراس، كوسيلة للايمان الحق، وأدواتها الإعداد والتكرار والإتقان، الذي يلزم وجوب استمرار التعلم وتلازمه مع استمرار الوجود الإنساني. لقوله تعالى:” إنما يخشى الله من عباده العلماءُ ” فاطر/28..
فالتربية والتعليم، إنما يزودان، كلية الانسان، بجميع جوانبها الروحية والمادية، بالمقومات والمهارات والمعارف التي تنظم وجوده وتمكنه من فهم ما يحيط به من عوالم، إضافة إلى كيفية التعامل معها. فالتوازن ضرورة حتمية تلازم الإنسان، كجسد وعقل ووجدان. لقوله تعالى: “وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا..”. القصص/77
لقد كرم الله تعالى الإنسان وخلقه في أحسن تقويم، ومنحه العقل للتعلم والحكمة ثم استخلفه الأرض.. فكان لزوم الإنسان استحقاق ما يليق بمكانته الرفيعة العالية، إضافة إلى ما يمكنه من أداء الدور الفاعل والفعال الذي كلفه الله تعالى به. مما أدى إلى تميزه بحقوق وخصائص ،تميزت بقدسيتها الالهية، مما يُكلِف الانسان واجب تحمل المسؤولية كاملة، في نفسه وفي الآفاق. هذه النظرة الإسلامية، إنما تعكس، شمولية الحقوق وانسانيتها عالميتها، وتعكس ايضا، تلازم الحقوق الفردية والجماعية لتحقيق المصلحة العامة. واهم مظاهر الشمول
1/ شمول العقيدة، ذات المصدر الواحد الأحد. التي خاطبت الانسان، روحا وجسدا، عقلا وضميرا، كما فسرت جميع القضايا الكبرى في هذا الوجود.
2/ شمول العبادة، والتي تمثل غاية الوجود الإنساني، باعتبارها المنطلق الإنساني الاول، يعني ضرورة تحقق رضى الله تعالى، اقوالا وعملا وتصرفات، وايضا خلافة الأرض تقتضي تحقق المنهج الإلهي المتناسق والمنسجم مع السنن الكونية.
3/شمولية التشريع، يعني كماله واكتماله، أي متعلق في كل ما يحدث ويصدر عن الإنسان من علاقات، بينه وبين ذاته، وبينه وبين غيره ، مما يحيط به،
لا بد للشريعة حكم فيها. بالأحكام شاملة كاملة، لا نقص فيها ولا قصور، ولا يؤثر الإنسان فيها ولا يقتضي تغيير قواعدها ولا نظرياتها الأساسية، ايٌ عارض أو طارئ.
4/ شمول الأخلاق .لم يترك الإسلام جانبا من جوانب الحياة الإنسانية إلا ورسم لها المنهج الاقوم والامثل لقواعد السلوك والتصرف. يعني ضرورة تحقيق التوازن: بين روح الإنسان وجسده، بين فردبته وجماعيته، بين دنياه واخرته، لأن الحياة بنظر الإسلام، وحدة متكاملة، توظف الإنسان كي يؤدي وظيفته الحقة: تجاه ربه، تجاه نفسه، تجاه الآخرين، تجاه ما يحيط به من بيئة، يؤديها بكل دقة وإتقان، بكل أمن وامان، بكل مساواة وتنسيق. مما يدفع الانسان إلى التزام شمول الممارسة الحياتية، بكل طاقاته واحاسيسه ووجدانه، والتي توافق فطرته السليمة دون انحراف، أي وجوب عدم الانجرار خلف الأهواء والنزوات والرغبات التي تمنع الحقوق وتعطل الحريات. فالمبادىء الأخلاقية تعتبر أدوات الانسان وسلاحه وذخيرته في إقرار الحقوق والواجبات والحريات،
ومن ثم تؤهله الى شرف استحقاقها وممارستها. وعكس ذلك، أي انعدام وجود القيم الأخلاقية أو ضعف فعلها، أو خلل اثرها في الانفس، إنما يعتبر من أكبر واعظم معوقات نقل تحقيق الحقوق من الفعل بالقوة إلى الفعل بالفعل، ونقلها من النصوص إلى واقع النفوس الملموس.
وهكذا وجب على الإنسان بضرورة التحلي بالخلق الحسن والالتزام بمكارم الأخلاق وتطبيقه عملا وممارسة، مع الذات و مع الآخرين ، والأخذ بذلك برهان ودليل للتمسك بتعاليم الإسلام عن قناعة ورضى، لأن في ذلك أشد تأثيرا وأعمق عملا.
سادسا: ميزة الضرورية
يتوجه الإنسان وبقوة الإيمان للسيطرة على الوجود، وما هذا إلا نزوع فطري. كما أن من المالوف أن تجد جماعات بشرية، ناقدة وجود العلوم والفنون والفلسفات، أي عديمة الحضارات، ورغم ذلك لا يمكن أن تجد جماعات من دون عقيدة دينية، أو تشريع ديانة، لأن ذلك اصل فطري لدى جميع الناس، سواء يعلمون أو لا يعلمون، متدينون أو غير متدينين، وهذا الأصل الفطري سيبقى داخل الإنسان كاحساس ديني وجودي ما بقيت الإنسانية. وللبيان فإن الله تعالى قد خلق الإنسان__ فطريا__ على عقيدة الاسلام، مقرونة بعديد من الغرائز والرغبات والميول. وبين هذه وتلك، أي بين الشهوات والايمان، يذهب الإنسان بفطرته إلى ما يحفظ نقاء معدنه وصفاء جوهره، إلى أن يصل مرتبة سمو الاستقامة، فيصبح سوي المنهج وقويم السبيل. ولكي يستقر الإنسان في الاكوان والعوالم المحيطة، لا بد له من رابط قوي متين، يضمن له ذلك الاستقرار، ثم يعرٍفه مكانته ودوره فيها.
من هنا كان لا بد من وجود عقيدة تحفظ وتضمن ذلك الوجود، على المستوى الإنساني والكوني، إضافة إلى وجوب حتمية الوجود الفطري للشعور والنزوع لدى الانسان. فالرابط الجدلي بين الإنسان، ذلك المخلوق المميز وبين علاقاته بكل ما يحيط به ، كونه سبدها، إنما يفرض الضرورية الوجودية كي تنظم وتقنن تلك العلاقات.
وهذا يعني بيان أن الإنسان بحاجة إلى عقيدة من اصل فطرته، أي مغروسة في ذاته وشعوره ووجدانه. أي ليس احساس طارئ ولا مكتسب. وللبيان، فإن أي انحراف عن سبيل إدراك هذه الحقيقة، فإن الإنسان سيحيا قلقا، مضطربا فيشقى ثم يفقد الاستقرار والاطمئنان. وهكذا فحاجة الإنسان إلى عقيدة، حاجة ضرورية، كي يحقق مكانته الكونية، ثم دوره ومقامه في هذه الحياة الدنيوية، إضافة إلى تحديد معالم رسالته وعمله واهدافه.
كل انسان يولد على الفطرة ، فالضرورة الفطرية تلزم المولود عقيدة دينية. لقوله تعالى:” وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا إلى شهدنا…..” الاعراف/172/ 173.
من هنا تبدأ حركة الإنسان الايمانية، بالعلاقة مع الله الواحد الاحد، وتنتقل إلى الاكوان المحيطة به لاكتشاف ما فيها، وما تكنه، فيتعرف عليها عن قصد وتصميم وبكل دقة وابداع، ثم ينتهي بذلك إلى إدراك مكانة ذاته في الوجود مع تحديد سلوكياته وتصرفاته في كل ما أدركه وتعرف عليه.
وهكذا فالضرورة، تفرض وجود انسان متدين (صاحب عقيدة) والسبب إنما يرجع لضرورة وجود نظم وقوانين ترسم للانسان سبل سلوك تلك الحياة التي يحياها، ومن جهة ثانية، تضمن (العقيدة) للقوانين أسباب نهوضها وتقدمها التي تحقق للانسان استقامته على أسس من الحق والعدالة والامن والسلام. فالتدين ضرورة فطرية غريزية، مع الإشارة إلى أنه تعالى قد ارتضى السلام، دين حق للناس جميعا. لقوله تعالى: “أن الدين عند الله الإسلام “. آل عمران/19.
وننوه ايضا، إلى أن اختيار الاسلام، كدين حق للناس جميعا، إنما يعود لأسباب ما مرت به الفطرة من مراحل تطورية، حتى انتهت إلى مرحلة الكمال والتكامل، متمثلة برسالة محمد(ص) والتي جاءت إلى البشرية جمعاء، تحقيقا لما حملته من تشريع انساني عالمي. لقوله تعالى: “اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا” المائدة/2. إنه دليل ما اشتمل عليه الإسلام من تطور رسالات سماوية، من يهودية ونصرانية، والتي قد تشكلت عبر امتداد زماني ،في العقيدة والمعتقد.
لقد عرض الإسلام القضية البشرية منذ نشأتها حتى غايتها.وان تعددت الديانات في الفروع والتكاليف والاعمال، فقد اتحدت في المصدر، أي أنها جميعها قد صدرت عنه، كجوهر تمثل في التوحيد الإلهي. الدليل في أن تلك الاديان قد اشتركت في العقيدة (عبادة الخالق العظيم)، ثم اُمِرت في معالجة الأمراض الأخلاقية والاجتماعية كي تستقيم على طريق الحق والعدل والمساواة والحرية…الخ. لقوله تعالى: “شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك ،وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب” الشورى/ 13. لقوله تعالى: “وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون”/ الانبياء/ 25.
الإسلام منهج وتشريع شامل لامور الدنيا والآخرة، بحيث يحقق صالح الفرد والجماعة، على السواء، فهو عقيدة دين، وايضا، فهو نظام حياة، من ان العلاقة بين الإنسان وبين خالقه، لا تنفصل عن تلك العلاقة بين الإنسان وبين اخيه الانسان، فالإسلام هو الذي ينظم ويوجه ويراقب ويسدد ثم يقدم الاجر والثواب في الدنيا والآخرة. فالعقيدة الإسلامية ضرورة انسانية، ترفع مستوى الإنسان وتكرمه، وتحافظ عليه من الانزلاق والانحراف المادي والمعنوي، إذ من خلالها، تقوم وتنشأ مجتمعات نظيفة، متعاونة
متكافلة، مستقيمة، لأن العقيدة الصحيحة السليمة،إنما هي التي تدعو وتأمر، بالتقوى والإيمان والاحسان، وتنهى عن الاساءة والتعدي والعدوان، يعني أنها هي التي تقدم الخير العام بعد تحقق الطاعات، قولا وعملا، وبكل هذا يترسخ الأمن وتطمئن القلوب.
وهنا يمكن القول، إذ لا وجود لقوة، مادية أو معنوية، تعادل قوة التدين (بما شرع الله) في ضمان وتماسك المجتمعات والمنظومات والمؤسسات، إذ لا تكفي قوة السلطات الحاكمة مع قوة تطبيق القوانين الوضعية، من إقامة مدينة فاضلة، أو وطن مستقر متقدم، تحترم الحقوق وتؤدي الواجبات على أكمل وجه، إلا إذا ارتكز على قوة العامل الروحاني ،الذي اسمه العقيدة، والمحملة بالقيم والأخلاق والمثل العليا، والتي تكفل عدم انتهاك الحريات وتقديسها لسمو النفوس البشرية
ختاما، تجدر الاشارة، إنه ليس بمقدور العلم وحده، يؤمن ضمان السلام والرخاء الإنساني العالمي، فالعلم سلاح ذو حدين، سبيل الارتقاء السوي، وفي الوقت نفسه، ادات قتل وتدمير، إذ لا يمكن للانسان، ومهما ارتقى بفكره وعلمه ونضج عقله، أن يحيط بكل ما يوفر للانسانية من امان واستقرار . فالله الخالق، وحده القادر الفاعل، والذي بيٌن ووضح للانسان العاقل، سبل الاستقامة الانسانية، ثم وضعه على الجادة الصحيحة، جراء التزاماته الكاملة والسليمة، مع خالقه وتشريعاته، عقيدة وعلاقات وسلوكا وتصرفات، لأنه، كانسان لم يُخْلَقْ سدى. لأن التدين نبتة فطرية اصيلة، فُطِر عليها الانسان، فتجذرت في ذاته وفي نفسه. فالدين رقيب ذاتي، يزكي النفس ويطهرها، ويحول بين الإنسان ونوازعه وشهواته، وهذا هو ما ينبغي أن تسعى الإنسانية إلى تحقيقه. ونلفت النظر إلى أن العقيدة الإسلامية، تحفظ النفس والمال والعرض، وهي ضرورية من ضروريات الإنسانية الراشدة.
خاتمة المقالة
في الختام، نخلص إلى أن كل ما اختصت به الإنسانية من مزايا الاستقامة والفضيلة، إنما هي اصول انبثقت من جوهر العقيدة الاسلامية، ثم ارتكزت على قواعد تطبيق منهجها وتشريعاتها، وسبيله مرتبط على الإيمان السليم، انطلاقا من مقولة أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه. والإنسان المؤمن مرآة اخيه الانسان.
وهكذا، فالانسانية، وبالمنظور الإسلامي، إنما تبدأ بالفرد وتنتهي بالمجتمع الإنساني العام، أي العالمية، كما أنها تبدأ بالدنيا وتنتهي بالاخرة، ضمن منهج متكامل وتشريع متناسق مقنن، من أجل تحقيق:
1/ تعريف الإنسان بخالقه، وبناء علاقة ودية بينهما، على قاعدة: إله خالق معبود، وإنسان مخلوق عابد. لقوله تعالى: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون/ الاعراف/158.
2/ تطوير سلوك الفرد وتوجيهه نحو الاستقامة والخير العام. لقوله تعالى: “قد أفلح من تزكى..”، الاعلى/14.
3/ تدريب وتمرين الفرد على مواجهة متطلبات الحياة المادية
4/ قيام منظومات إنسانية، يخاف أفرادها (رؤساء ومرؤسين) الله فيحققون تشريعاته العادلة والحقة، فيما بينهم
5/ الدعوة الحقة إلى نشر العقيدة عالميا. (فهما وممارسة). لقوله تعالى: “كنتم خير أمة أخرجت للناس.. “/ آل عمران/110.
6/ غرس الإيمان واستنباته، مفهوما وممارسة، بالوحدة الإنسانية والمساواة بين البشر. لقوله تعالى: “وأن هذه امتكم أمة واحدة وانا ربكم فاتقون”/ المؤمنون/ 52.





